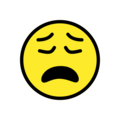الصيد في تراث العرب " لذة " ورياضة تحكمها العادات والأعراف
الباحث والمؤرخ أحمد محارب الظفيري : اختفى الصيد بالكلاب السلوقية فاختفت الأرانب من البراري
ريهام محمد
التراث العربي الأصيل يزخر بالقيم والمبادئ والأخلاقيات التي كانت وجهاً آخراً للشهامة والفطرة السليمة قبل الإسلام وبعده، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فالعرب ربطوا بين تقاليدهم وعاداتهم وبين المحافظة على الحياة الفطرية عند العرب يدرك أنها لم تكن رياضة عبثية أو عشوائية أو حتى جائرة بل كانت سبيلاً لتوفير الغذاء من دون الأضرار بالبيئة والتسبب في اختلال توازنها.
والباحث في التراث العربي المؤرخ أحمد محارب الظفيري يملك من المعلومات والذكريات ما يجعل الحديث عن الصيد عند العرب موضوعاً شيقاً يطرب الأذان بقيمه وعبره، وقد حاولنا قراءة تفاصيل هذا الفصل الهام من حياة العرب من خلال ذاكرة المؤرخ الكويتي الظفيري حيث سرد بأمانة وحب حكاية الصيد عن العرب وجاءت التفاصيل على النحو التالي:
في البداية قال الباحث الظفيري: عرف العرب منذ جاهليتهم القديمة – والجاهلية لفظية مجازية لا تعني الجهل وإنما تعني العرب في عصور ما قبل الإسلام الحنيف، والصيد كان وسيلة مهمة من وسائل الحصول على الغذاء اللذيذ وهو لحم الصيد، وعملية الاصطياد والقنص يسميها العرب الأوائل والأواخر صيداً، وكذلك الطرائد المصطادة هي الأخرى يسمونها صيدا.
وتابع: ولقد شغف العرب شغفا عارما بحب الصيد والقنص وانهمكوا بتدريب وتعليم حيواناتهم المستخدمة لهذا الغرض من خيل وجمال وصقور وكلاب وفهود وعلموا أولادهم على هذه الرياضة الممتعة رياضة الصيد التي تغرس في عقولهم وضمائرهم معاني الشجاعة والفروسية وتعزز فيهم روح الصبر والصمود على القتال والنزال.
فرياضة الصيد هي دواء وغذاء للأجسام والعقول، لذلك لا نستغرب عندما نجد أن أجدادنا العرب القدماء قد أطلقوا على هذه الرياضة المحببة لكل واحد منهم مسمى «اللذة» وفعلاً الصيد لذة تفوق كل اللذات عند عرب الأمس وعرب اليوم، فالصياد أو القناص ينسى نفسه أثناء مطاردته للطريدة ويعيش في نشوة عارمة يعرفها كل من مارس هذه الهواية، أو رافق القوانيص «الصيادين» في مقانيصهم «صيدهم».
فهذا أبو الحارث الملك الضليل الشاعر إمرؤ القيس حندج بن حجر الكذري يذكر التسمية الشائعة المفضلة لهواية الصيد عند العرب وهي «اللذة» في هذا البيت من شعره، يقول:
كأني لم أركب جواداً «لذة» ... ولم أتبطن كاعباً ذات خلخال
الصيد في الإسلام
وتابع الظفيري حديثه عن الصيد لكنه أشار هذه المرة إلى الصيد بعد الإسلام العظيم حيث قال: بعد أن أصبح العرب بفضل الإسلام سادات الدنيا، تأثروا بمعطيات ومسميات حضارات الأمم الأخرى التي فتحوها ونشروا الإسلام في ربوع ديارهم، ففي العهد العباسي صار الصيد والقنص علماً يدرس في دوواوين الخلفاء والملوك والأمراء وصار لهذا العلم رجاله وأصحابه المتخصصين في كل ماله علاقة بشئونه وملحقاته وأصبح اسم هذا الفن أو العلم هو «البزدرة» أو «البيزرة» أو البزيرة وأصل التسمية فارسية آتية من كلمة بازدار أي دار الباز.
والباز طير جارج مثل الصقر، حيث كان الطير الباز من أفضل ضواري الطيور الجارحة المستخدمة للصيد عند الأكاسرة ملوك الفرس بينما المفضل عند العرب عندما كانوا في جزيرتهم قبل أن يتحضر هو طير الصقر، وأصبح مسمى الصيد أو المعلم المختص في شئون البيزرة أو البزدرة هو بازياد أو بيزار أو باز دار أو باز دراين والجمع باز داريه وكانت لهم دار خاصة مجهزة ومزودة بكل ما يحتاجونه لشئون وظيفتهم ولهم رئيس خاص يسمى كبير البازداريه أو كبير البيازرة يشرف على أمور البزدرة ويراجع السلطان أو الملك أو الأمير في موضوع الصيد والقنص ومواعيده وعلم البيزرة أو البزدرة يتناول بالبحث فن رياضة الصيد والقنص بالطيور الجوارح «ضواري الطير» مثل الصقور والشياهين وطريقة علاجها وتربيتها وتدريبها ويتناول بالبحث والدراسة في كل الأمور التي لها علاقة بالصيد وما يرافق هذه العملية من حيوانات ومعدات وتعليمات.
يخرج الصيادون إلى البراري والجبال عادة في موسم اعتدال الجو ويصطادون الغزلان والأرانب البرية وطيور الحبارى والقطا والحجل والدراج والبط وأنواعاً أخرى من الصيد المتوفر في البيئة التي يتجولون فيها.
ومن الكتب المؤلفة في البيزرة أو البزدرة نذكر لكم كتاب الجمهور في البيزرة لعيسى بن حسان الدلدي وكتاب المصايد والمطارد لكشاجم.
الصيد بالكلاب السلوقية
واصل الظفيري سرد لتفاصيل رياضة الصيد عند العرب حيث استهل الحديث عن أساليب وطرق الصيد العربية باشارته إلى الصيد بواسطة الكلاب السلوقية «الكلاب الضواري» حيث قال: الكلاب الضواري هي كلاب مدربة ومعلمة منذ الصغر على أساليب الصيد والقنص فنشأت ضارية «متعودة» على الصيد، تصيد الأرانب والطيور والغزلان، مطيعة غاية الطاعة لصاحبها وتنفذ أوامره بحذافيرها وكلاب السلوقية الذكر منها «سلوقي» والأنثى «سلقة»، والكلب السلوقي هو كلب ذائع الصيت في الصيد والقنص عند العرب الأوائل والعرب الأواخر. ويختلف عن بقية الكلاب بسرعته الفائقة وحركته الرشيقة، وتكون أذانه طويلة متدلية ويتميز بضمور البطن وأناقة الشكل وجاء في بعض المراجع التاريخية أن الكلاب السلوقية تنسب إلى مدينة «سلوق» في اليمن.
وتردد اسم هذه الكلاب الممدوحة في الصيد في الشعر والأدب العربي منذ العصر الجاهلي وحتى هذا العصر، فهذا الشاعر الأموي القطامي يصف كلاب الصيد السلوقية بالحصن التي تجرر الأرسان، ويقول:
ومعهم ضوار من سلوق كأنها ... حصن تجول تجرر الأرسان
فكيف تفلت الطرائد من هؤلاء الصيادين الذين معهم مثل هذه الضواري!
طريقة الصيد
أما طريقة الصيد بالسلوقي فيشرحها الظفيري قائلاً: حالما يرى الصياد الغزال والأرانب فإنه يطلق كلبه سلوقية على طريدته فيطرحها أرضا ويجلبها لصاحبه، أو قد يمسكها حتى يأتيه صاحبه فيذبحها لتصبح حلالاً، والشئ الذي يجب أن نعرفه أن الكلب لا يذبح الطريدة ولا يجرحها وإنما يمسكها حتى يأتيه صاحبه ويأخذها منه. ويصف الجاحظ في كتابه «الحيوان» كيفية مطاردة الكلب للطريدة عند عرب زمانه قائلاً: على أن للكلب في تتبع الدراج والأصعاد خلف الأرنب في الجبل الشاهق من الرفق وحسن الاهتداء والتأني ما لا يخفي مكانه على البيازرة والكلابين.
ويعود الظفيري إلى حديثه ويقول: ويوم كان الصيد بواسطة الكلب كانت الأرانب تملأ البراري أما في زمان البارود «البندقية» والسيارة فعلى الأرانب السلام لقد اختفت من صحارينا!
والشئ الذي يجب ألا نغفله أن الإسلام الحنيف أباح لنا استخدام كلاب الصيد المدربة وكلاب حراسة الماشية، والمزارع والبيوت، أما ما عدا ذلك فهو محرم شرعاً وجاء في الحديث الشريف «من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم» وجاء في الحديث الشريف أيضا «من اتخذ كلباً أو كلب زرع أو غنم أو صيد نقص من أجره كل يوم قيراطان».
المصدر : مجلة بيئتنا - الهيئة العامة للبيئة - العدد 102